بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمد وعلى آله الطيّبين الطاهرين
مشروعية الخلوة
ذهب أهل التصوف في تربية المريدين في سيرهم إلى الله سبحانه إلى جعل الخلوة أول منازل السير إلى الله سبحانه وذلك للأثر الناتج عن الخلوة.
والخلوة في أصلها مشروعة و ليست ابتداعٌ من أهل التصوف كما يحاول إظهاره بعض مدّعي العلم وهي نوعٌ من الاعتكاف الذي ندبنا إليه الإسلام وهي طريقُ جميع الأنبياء ومن بعدهم من الصالحين.
ولقد حدّثنا الله سبحانه عن سيّدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم عندما اعتزل قومه الذين لم يؤمنوا برسالته فقال تعالى: [وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (48) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا] (سورة مريم)
والخلوة هي نوعٌ من الفرار إلى الله الذي ألزمنا الله عزّ وجلّ به فقال سبحانه: [فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ] (الذاريات: 50)، وهي هجرةٌ إلى الله تعالى: [وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ] (الصافات :99) والخلوة سنّةٌ ماضيةٌ في الأديان السابقة.
فلقد واعد سيّدنا موسى ربّه ثلاثين ليلة ثمّ تمّت بعشر فتمّ ميقات ربّه أربعين ليلة، ومريم بنت عمران كان لها اعتكافها وميقاتها في المحراب، قال تعالى: [وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا] (مريم: 16)، وكان لسيّدنا زكريا اعتكافه وميقاته ثلاث ليال سويا وكل ذلك ثابتٌ في كلام الله عزّ وجلّ.
وقد ثبت أنّ سيّدنا رسول الله ﷺ اختلى قبل البعثة في غار حراء الليالي ذوات العدد، حتّى بعد البعثة كان يختلي ﷺ في العشرين أو في العشر الأواخر من رمضان.
ومن شرف الخلوة أنّ أول ما نزل عليه الوحي كان في خلوة الغار فنزل قوله تعالى [اقرأ باسم ربك الذي خلق] فشُرّف المكان والزمان ونال الشرف صاحب الخلوة سيّدنا رسول الله ﷺ.
فأصبحت الخلوة بهذا الفعل منه ﷺ سنّةٌ نبويّةٌ ومنهاجٌ ربانيٌّ ينبغي على المؤمن التزامه وتطبيقه لمن أراد اتّباع السنّة واقتفاء أثره ﷺ.
فهل بعد هذا البيان الواضح من الله سبحانه لكلّ صاحب قلبٍ سليمٍ وعقلٍ راجحٍ إلّا أن يُقرّ ويعترف بفضل الخلوة ومكانتها ومشروعيتها في حياة الإنسان المؤمن.
وقد ورد ذكر الخلوة في الأحاديث النبوية بمعنى العزلة، فلقد روى الإمام مسلم في صحيحه في باب فضل الجهاد والرباط عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أيّ النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبِيلِ اللَّهِ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ في شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ».
فالاعتزال و الانعزال والخلوة عن الناس شيءٌ معروفٌ منصوصٌ عليه في القرآن والسنة وكلّها مترادفةٌ في المعنى، فالخلوة هي العزلة. وقد فرّق بعضهم بين الخلوة والعزلة فقال: الخلوة من الأغيار والعزلة من النفس وما تدعو إليه ويُشغل عن الله، وهي أعمّ من الخلوة.
فليس كلّ من اختلى قد حقق العزلة من النفس وحظوظها وتوجّه إلى الله، فالخلوة كثيرةٌ والعزلة قليلة، لكنّ المعنى واحد، فكلٌّ منهما معناه الاعتزال عن الناس وتصفية الذهن والقلب.
ما هو الهدف من الخلوة؟
1-التزكية والتطهير: فالخلوة تساعد على تطهير القلب من الأغيار والتحلّي بالأخلاق الحميدة.
2-التقرب الى الله: فمن خلال الذكر والدعاء والتفكّر يسعى المريد للوصول إلى درجة القرب من الله.
3-كشف الأسرار: الخلوة قد تكشف للمريد أسراراً عن عوالم الوجود وعن نفسه.
4-الوصول إلى مراتب الإحسان: فالخلوة الخاصّة تهدف إلى تحقيق مراتب الإحسان والوصول الى درجة الشهود.
فهي وسيلةٌ لتخلّص المريد من الآفات والعيوب التي تطرأ على قلبه وسلوكه وليصفو من كدورات الحياة الماديّة التي طغت في زماننا هذا، فيصفو فكره ويتنوّر قلبه وتُشرق روحه.
وليس الغرض من الخلوة إلّا الوصول الى الأنس بالله تعالى فإذا حَصَلَ الأنس بالله تعالى للعبد أشرقت الأنوار الإلهية والأسرار الربانية والفتوحات الإلهية على قلب المريد من هذه الخلوة فيعلم ما لم يكن يعلمه، ويفهم ما لم يكن يفهم من قبل.
مفهوم الخلوة
يذكر الإمام الغزالي في كتاب الإحياء مفهوم الخلوة وطريقتها فيقول: “وزعموا أنّ الطريق في ذلك أولاً بانقطاع علائق الدنيا بالكليّة، وتفريغ القلب منها وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاه، بل يصير قلبه إلى حالةٍ يستوي فيها وجود كلّ شيءٍ وعدمه، ثمّ يخلو بنفسه في زوايةٍ مع الاقتصار على الفرائض والرواتب ويجلس فارغ القلب مجموع الهمّ ولا يفرق فكره بقراءة قرآنٍ ولا بالتأمل في تفسيرٍ ولا بكتب حديثٍ ولا غيره، بل يجتهد ألّا يخطر بباله شيءٌ سوى الله تعالى. فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلاً بلسانه الله الله على الدوام مع حضور القلب حتى ينتهي إلى حالةٍ يترك تحريك اللسان ويرى كأنّ الكلمة جاريةٌ على لسانه ثمّ يصبر عليه إلى أن يمحي أثره).
ويذكر سيّدي عبد القادر عيسى قدّس الله سرّه في كتابه “حقائق عن التصوف” مفهوم الخلوة وفوائدها فيقول: “الخلوة انقطاعٌ عن البشر لفترةٍ محدودة، وتركٌ للأعمال الدنيوية لمدةٍ يسيرة، كي يتفرّغ القلب من هموم الحياة التي لا تنتهي، ويستريح الفكر من المشاغل اليومية التي لا تنقطع، ثمّ ذكرٌ لله تعالى بقلبٍ حاضرٍ خاشع، وتفكّرٌ في آلائه تعالى آناء الليل وأطراف النهار، وذلك بإرشاد شيخٍ عارف بالله، يُعلِّمه إذا جهل، ويُذكِّره إذا غفل، ويُنشّطه إذا فتر، ويساعده على دفع الوساوس وهواجس النفس”.
طريقة الخلوة وشروطها
يذكر الغزالي رحمه الله طريقة الخلوة ومراحلها ومقاماتها، فيقول: “إنّ الشيخ يُلزِم المريد زاويةً ينفرد بها، ويوكّل به من يقوم له بقدرٍ يسيرٍ من القوت الحلال -فإنَّ أصل الدين القوت الحلال- وعند ذلك يلقّنه ذكراً من الأذكار، حتى يشغل به لسانه وقلبه، فيجلس ويقول مثلاً: الله، الله، أو سبحان الله، سبحان الله، أو ما يراه الشيخ من الكلمات، فلا يزال يواظب عليه، حتى يسقط الأثر عن اللسان، وتبقى صورة اللفظ في القلب، ثمّ لا يزال كذلك حتى تُمحى من القلب حروف اللفظ وصورته، وتبقى حقيقة معناه لازمةً للقلب، حاضرةً معه، غالبةً عليه، قد فرغ عن كلّ ما سواه، لأنّ القلب إذا اشتغل بشيءٍ خلا عن غيره – أيَّ شيء كان – فإذا اشتغل بذكر الله تعالى وهو المقصود، خلا لا محالة من غيره”.
وبهذا نستنتج أنّ مفهوم الخلوة مأخوذٌ من الشريعة الإسلامية، منصوصٌ عليه في الكتاب والسنّة، وليس فعل الصوفية له إلّا اتّباعاً للنبي ﷺ ومن حرصهم على تحصيل القرب من الله والأُنس به.
والحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.
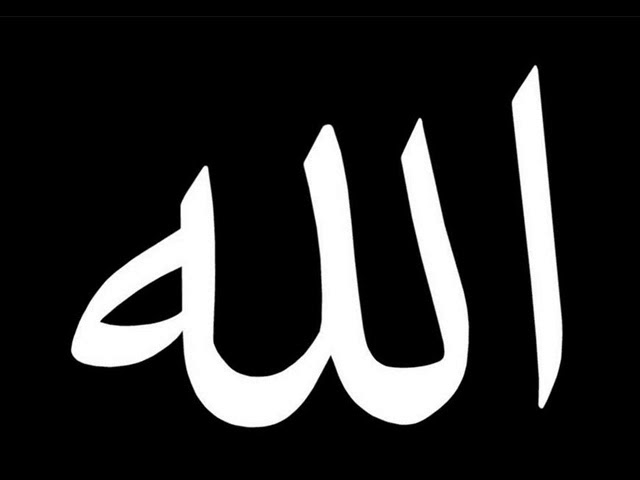
اترك تعليقاً