لقد اتصل نور السماء بالأرض عن طريق النبوة، والنبوة تتمثل برجالٍ اختارهم الله تعالى من الأزل لسابق علمه باتصافهم بما يؤهلهم لحمل أمانة التبليغ، فأدى الأنبياء ذلك على الوجه المطلوب، وكان لهم أتباعٌ وحواريون تربَّوا على أيديهم وأخذوا عنهم الدين، فكانوا صورةً صادقةً عن أنبيائهم ومرآةً تعكس ما رأَوهم عليه.
ولقد قام هؤلاء الأصحاب بنقل ذلك لمن تبعهم وصحبهم، فكانوا كذلك صورةً صادقةً عمن نقل لهم وحي السماء، وعلى هذا المنوال تناقلت الأمة الدين، وأما أخذ الدين عن الصحيفة والمخطوط في الكتب فما عُرف عند المسلمين إلا في العصور المتأخرة، وإن وجدت في القرون الأولى على نحو ضيق إلا أن الطلبة ما كانت تستغني بالكتاب عمن تقرؤه عنده، وتستجيزه في إقرائه لمن رغب.
وهذا ما سارت عليه الأمة ما يزيد على ثلاثة عشر قرناً، ولقد ظهرت في ذلك إجازات في كل فن من الفنون كالحديث والفقه والقراءات والتصوف، بل ولا تقرأ في ترجمة أحد من العلماء إلا وترى فيها ذكر شيوخه وتلامذته ليُعرف بشيوخه وتعرف تلامذته به.
وإننا لنشهد إلى يومنا هذا ما تبقى من هذا المنوال، وإلى زماننا هذا هناك من أجيز ويجيز وقرأ البخاري على شيخه ويقرأ عليه، ولقد كانت الأمة في هذه القرون تعيب على من أخذ العلم عن الصحيفة ولا تعتدّ به، بل وكثيرٌ من علماء الحديث لا يجيز قراءة الحديث إلا لمن عنده به سند، وعلم القراءات لا يؤخذ إلا تلقياً لتستقيم القراءة ويصح النطق، والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
إذاً فمدار الدين على التبليغ، إذ به اتصال السند، قال ﷺ: “بلغوا عني ولو آية”، فالتبليغ والتبليغ وحده، ولا يغني عنه كتاب كاتب ولا صوغ مؤلف… لماذا؟ إن في التبليغ معنىً زائداً على المبلَّغ، وإنك لتجد في التبليغ ما لا تجده في المبلَّغ قراءةً، ذلك أن في التبليغ أموراً ثلاثة: الرواية والدراية وحال المبلِّغ، وليسَ في قراءة البلاغ ذلك، فالذي يتلقى الحديث تبليغاً ممن سمع ليس كمن وجد الحديث في كتاب.
فرسول الله ﷺ روى على مسامع أصحابه آياتِ القرآن وما أوتيه من الحديث الشريف فسمعوا ألفاظه، وعرّفهم بمضمونها فدروها، وتخلّق بمعانيها أمامهم فتأثروا بحاله وهو يرويها، فنقلوها لمن بعدهم كذلك فعَرَّفوا أتباعهم كيفية لفظها وأوضحوا لهم مضمونها وتخلقوا بها أمامهم لينقلوا القول مقروناً بحال من قاله.
ومن العلماء من اهتم برواية الأثر قرآناً وسنة، وهم أهل القراءات والحديث، ومنهم من اهتم بدرايته وفهمه، وهم الفقهاء، وأما الحال المقرون بقول القائل فهو محل اهتمام الصوفية حتى أُثِر عنهم القول: “حال رجل في ألف رجل خير من قال ألف رجل في رجل”.
فلأجل هذا لا يغني الكتاب عن التلقين، والدين أخذ وليس بعلم، والدين روح تنفخ لا مسائل تنسخ، فالذي يقرأ عن خلق رسول الله ﷺ مع من يعامله ويجد في كتب الشمائل أن رسول الله ﷺ ما كان ينتصر لنفسه قط لا تحمله القراءة على التخلق بذلك إلا إن أخذه تلقياً عمن وُجد هذا الحديث فيه تخلقاً.
إن دراسة هذا الدين تكون عند من تجد الدين عنده وفيه وبعمله، فتقرأ الشمائل فيه سلوكاً، فيحملك هذا على اتباعه، وهنا لابد من الإشارة بعد هذا الكلام إلى ما يعانيه الدعاة اليوم، وهو ما أسميناه أزمة الدعاة، فلقد عرفوا الكثير من آيات الكتاب وأحاديث السنة، وقرؤوها وأبدعوا في استخراج أسرارها، وتخرجوا من ميادين الجامعات، وأضفت عليهم الدراسات الأكاديمية ألقاباً وألقاباً، ولكنهم إلى اليوم لم تنضج ثمار جهودهم، ولم يفلحوا في تغيير المحيط من حولهم، لماذا وهم من عرف ودرس وقرأ؟
لا يؤخذ الدين إلا تلقّياً؛ لأن في التلقي تأثراً بحال الملقّي، وهذا لا يكون إلا بالصحبة، وهو من أهم ثمارها، ولذلك اشترط الصوفية الصحبة حتى جعلوها أساس التصوف، والذي لا يأخذ الدين تلقياً كثيراً ما يتعارض سلوكه مع ما يعلم، ويخالف القول منه العمل، فمن أين له الحال والحال لا يؤخذ إلا من صدور الرجال، وإلا فقد حذر الله ورسوله من مخالفة القول للفعل ((كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)) [الصف 3].
يقول الله تعالى آمراً نبيه محمداً ﷺ: ((قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)) [يوسف 108]، فمن رغب بالدعوة فسبيلها الاتّباع، والاتّباع يكون باقتفاء أثر المتّبَع، ولا يكون بغير وجود المتبوع أو من اتبعه أو من اتبع من اتبعه، وهذا ما نعني به اتصال السند.
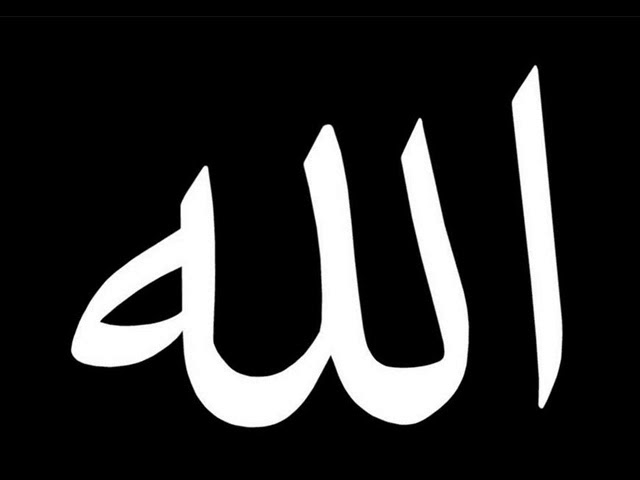
اترك تعليقاً